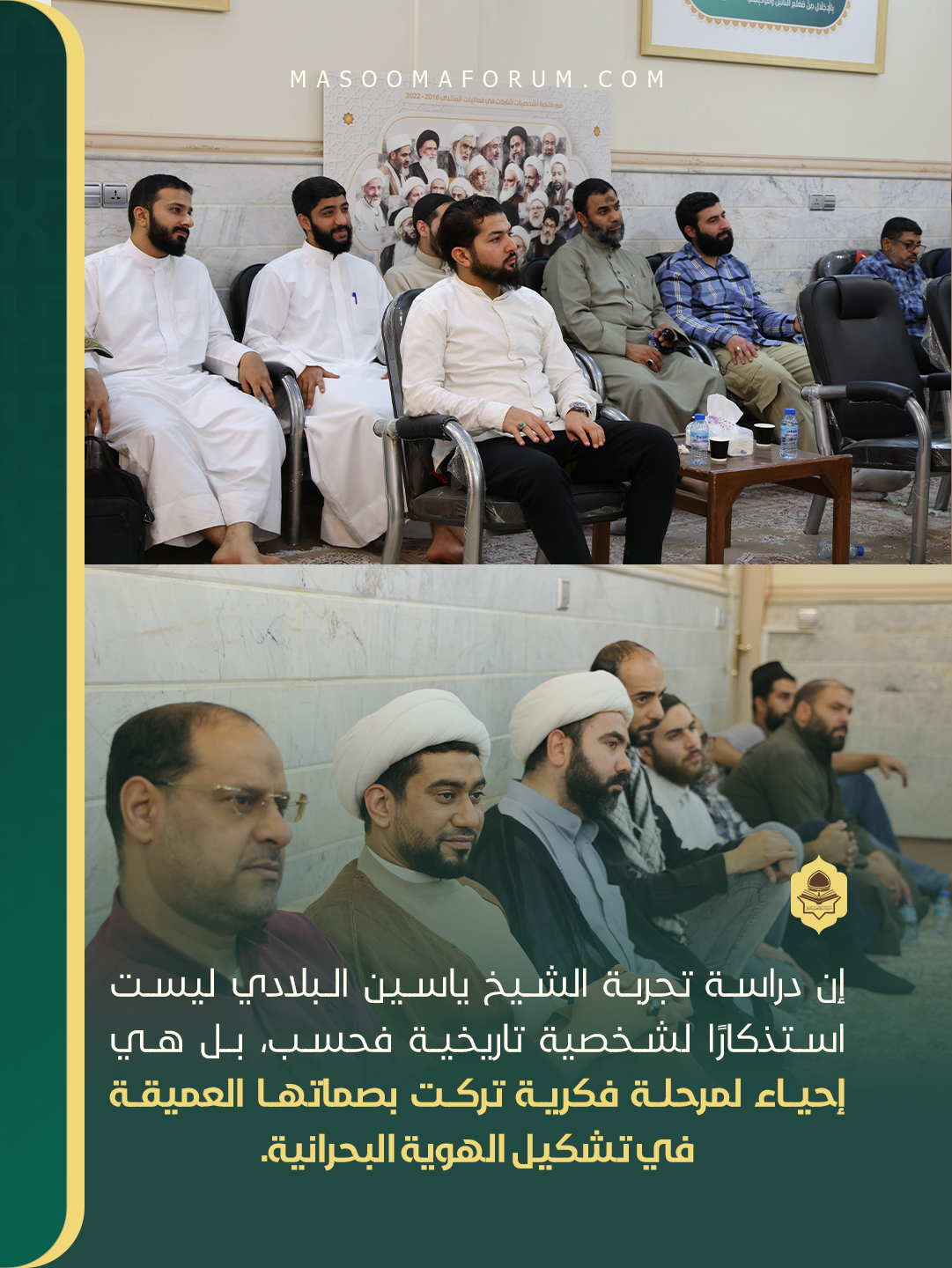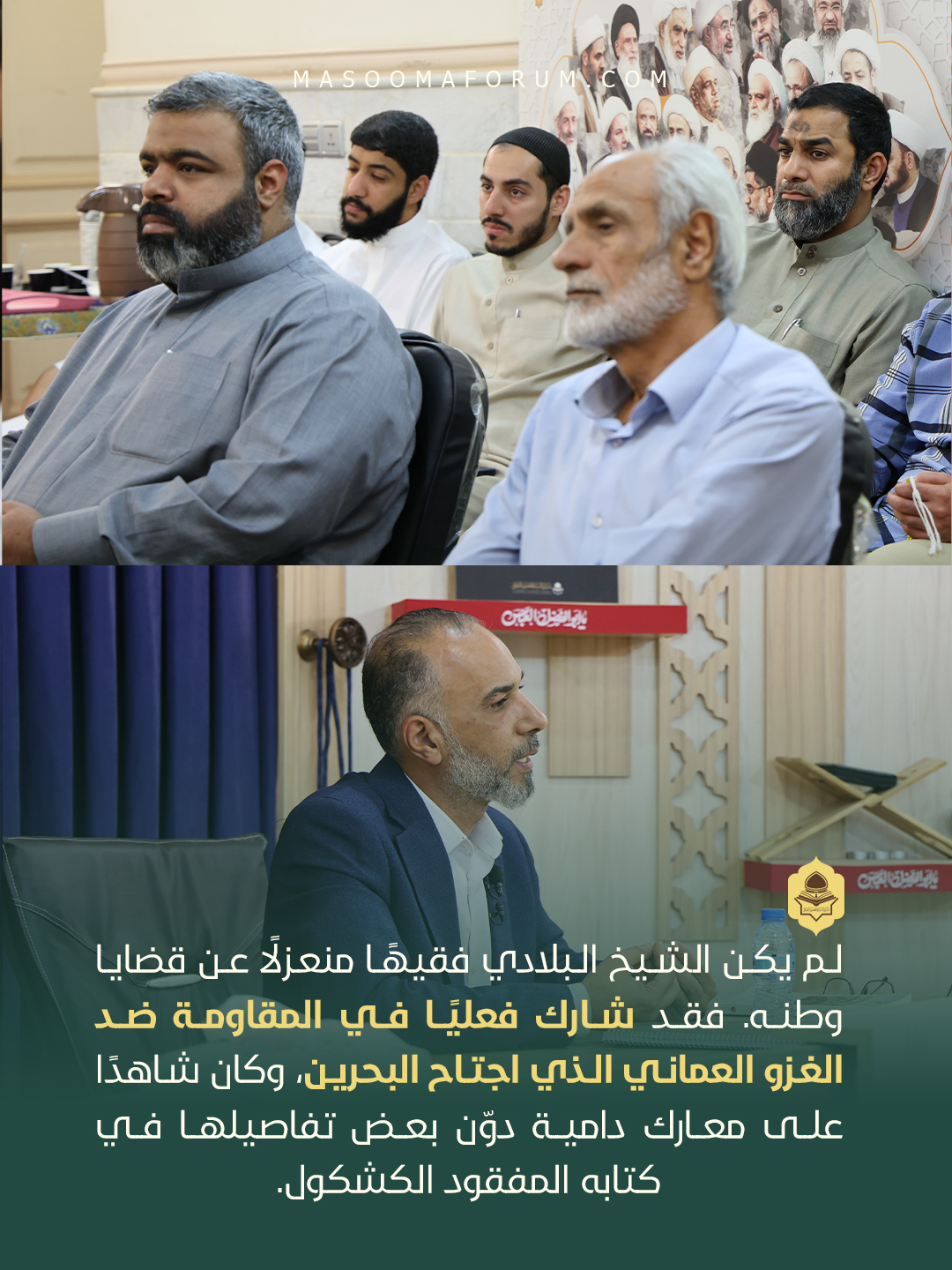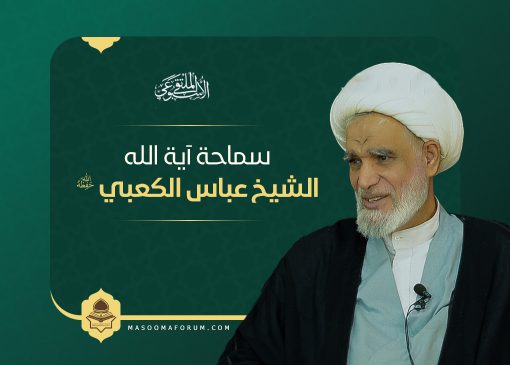الفقيه البحراني ومحنة خراب البحرين – الأستاذ عباس المرشد
الفقيه البحراني ومحنة خراب البحرين – الأستاذ عباس المرشد
بمشاركة:الأستاذ عباس المرشد
التغطية المصورة:
التغطية الصوتية:
التغطية المكتوبة:
استضاف منتدى السيدة المعصومة الثقافي بمدينة قم المقدسة ضمن برنامج الملتقى الأسبوعي سماحة الأستاذ عباس المرشد بتاريخ16 أكتوبر 2025 في جلسة ومحاضرة في كتاب الفقيه البحراني ومحنة خراب البحرين ، وهنا تلخيص لأهم ما تفضل به سماحته
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين.
تمهيد:
إنّ من أبرز المهام المنوطة بالباحثين في التاريخ الإسلامي، ولا سيما في التاريخ البحراني، إعادة بناء الوعي بالهوية العلمية والفقهية لتلك المرحلة الخصبة من تاريخ الأمة، التي شهدت صراعًا فكريًا محتدمًا بين المدرستين الإخبارية والأصولية، وتفاعلًا خلاقًا بين الدين والمجتمع والسياسة.
لقد مثّلت تلك الحقبة ميدانًا واسعًا لإنتاج العلماء والفقهاء الذين لم يقتصر دورهم على التأليف والبحث، بل انخرطوا في الدفاع عن أوطانهم وقيمهم، وأسهموا في تشكيل ملامح الفكر الشيعي في العالم العربي.
وفي طليعة هؤلاء يبرز اسم الشيخ ياسين بن الشيخ صلاح البلادي، أحد فقهاء القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، الذي مثّل حلقة مركزية في تطور المدرسة البحرانية وامتدادها في الفكر الإمامي.
🔹 أولًا: نبذة عن الشخصية وسياقها التاريخي
وُلد الشيخ ياسين البلادي قرابة عام 1690م، في زمنٍ كانت فيه البحرين تعيش واحدة من أكثر مراحلها الفكرية والسياسية اضطرابًا. فقد تداخلت فيها التحولات الفكرية داخل الوسط الشيعي مع التغيرات السياسية والإقليمية التي أثّرت على هوية المنطقة.
في تلك البيئة نشأ البلادي وتكوّن علميًا على أيدي كبار الفقهاء البحرانيين، وفي مقدمتهم:
- الشيخ عبد الله السماهيجي، الذي كان أستاذه ومرجعه في القضايا الفقهية والحديثية، وارتبط معه بمراسلات علمية عميقة تضم قرابة مائة مسألة فقهية وأصولية.
- الشيخ سليمان الماحوزي، المحقق البحراني المعروف، الذي كان من رموز الاتجاه العقلي في الفقه الإمامي.
تميّز الشيخ البلادي باتساع اهتماماته العلمية، فإلى جانب الفقه والحديث، انشغل بعلم اللغة والرجال، وترك ما يزيد على عشرين مؤلفًا، لم يصل منها إلا القليل، من أبرزها:
- معين النبي في من لا يحضره الفقيه: وهو شرحٌ لمشيخات الشيخ الصدوق، يتضمن تحليلاتٍ رجالية دقيقة، تكشف عن منهجه في نقد الأسانيد وتمييز الرواة.
- المحيط في علم الرجال: مخطوط نفيس يجري تحقيقه في مركز الشيخ الطوسي، يُظهر سعة اطّلاعه على تراجم المحدّثين ومصادر الرواية الإمامية.
- القول السديد في شرح كلمة التوحيد: عملٌ في العقيدة لم يصلنا منه سوى صفحة واحدة، إلا أنها تكشف عن عمقٍ فلسفي في تناول قضايا التوحيد والتنزيه.
إن هذه المؤلفات الثلاثة تشكل شواهد على تكامل منهجه بين الفقه النظري والتحقيق الرجالي والبحث الكلامي، مما يضعه ضمن العلماء الموسوعيين الذين جمعوا بين النقد النصي والإنتاج الفكري الممنهج.
🔹 ثانيًا: المدرسة البحرانية – الجذور والمسار
🧭 النشأة الفكرية:
تعود جذور المدرسة البحرانية إلى القرن السادس الهجري، حين بدأت تتبلور كاتجاه علمي وفلسفي يمزج بين التحقيق العقلي والتذوق الروحي، مستفيدًا من التجارب العلمية في الحلة والنجف وأصفهان، مع احتفاظه بخصوصيته المحلية.
ومن أبرز روادها الأوائل:
- الشيخ ميثم البحراني، الذي مثّل حلقة وصل بين الفكر الفلسفي والعقيدة الإمامية.
- الشيخ أحمد المتوج البحراني والشيخ مفلح الصيمري، اللذان أسهما في تقعيد أصول المنهج الفقهي البحراني.
- المحقق الشيخ سليمان الماحوزي الستري، الذي جسّد توازن المدرسة بين النص والعقل.
- الشيخ يوسف العصفور، الذي توّج الاتجاه الإخباري بمنهجه الحرفي في التعامل مع النصوص.
🏛 الدور العلمي:
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، بلغت المدرسة البحرانية أوج نشاطها، فغدت مركزًا علميًا موازيًا لحوزات النجف وقم وأصفهان. وقد تميّزت بإنتاج فقهاء جمعوا بين عمق العلم وممارسة القيادة الاجتماعية والسياسية.
ورغم هذه المكانة، فإن التاريخ التقليدي غيّبها أو همّشها، نتيجةً لهيمنة السرديات المركزية التي ركزت على المراكز الكبرى في العالم الشيعي، متناسية دور الجزر الخليجية كمحاضن علمية مقاومة.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة قراءة هذا التراث بوصفه نواة فكرية وسياسية متكاملة أسهمت في حفظ الهوية الإسلامية في الخليج.
🔹 ثالثًا: الشيخ ياسين البلادي والهوية البحرانية
📚 في الجانب العلمي:
يكشف ما تبقى من مؤلفات الشيخ البلادي عن نزعةٍ نقدية تحليلية، تميل إلى التحقيق في النصوص وتفكيك الروايات، بعيدًا عن النقل المجرد.
فهو في علم الرجال مثلاً، لا يكتفي بجمع التراجم، بل يقارن بين المصادر، ويضع معايير للوثاقة والانحراف، مما يجعله قريبًا في منهجه من الروح الأصولية التحليلية رغم انتمائه إلى البيئة الإخبارية.
كما يُعد من العلماء الذين ربطوا العلم بالواقع، فلم يكن الفقه عنده مجرد تنظير، بل ممارسة أخلاقية واجتماعية تهدف إلى تحقيق العدالة الدينية في المجتمع.
⚔ في الجانب الجهادي:
لم يكن الشيخ البلادي فقيهًا منعزلًا عن قضايا وطنه. فقد شارك فعليًا في المقاومة ضد الغزو العماني الذي اجتاح البحرين، وكان شاهدًا على معارك دامية دوّن بعض تفاصيلها في كتابه المفقود الكشكول.
وتُظهر الشهادات التاريخية، مثل ما أورده صاحب أنوار البدرين، أن البلادي تعرّض لجراحات في جسده أثناء القتال، ووصف آثار السيوف والرمح في مقدمة كتابه، في مشهد يجمع بين الفقه والسيف، والعلم والجهاد.
🌍 الاغتراب والهجرة:
بعد سقوط البحرين ووقوع المجازر، اضطر الشيخ البلادي إلى الهجرة إلى شيراز، حيث واصل نشاطه العلمي ونشر المعرفة بين طلابه، ثم عاد لاحقًا إلى وطنه بعد استقرار الأوضاع.
وتعبّر هذه التجربة عن نموذج الفقيه المهاجر الذي لا ينقطع عن مجتمعه، بل يحمل علمه معه أينما حلّ، فيستمر في بناء الوعي ونقل الخبرة للأجيال الجديدة.
🔹 رابعًا: المرجعية البحرانية ودورها الاجتماعي
لقد كان النظام البحراني التقليدي في تلك المرحلة يقوم على ثنائية الحكم بين:
- السلطة السياسية المتمثلة في الحاكم المعين من الدولة الصفوية أو القوى المحلية.
- السلطة الفقهية التي تمارس دور المرجعية الدينية والاجتماعية.
وكان الفقهاء هم المرجعية الواقعية للشعب، يتولون القضاء، والإفتاء، وتنظيم العلاقات الاقتصادية، خصوصًا في نظام الغوص والضرائب.
ومن النماذج البارزة:
- الشيخ سليمان الماحوزي، الذي أصدر فتاوى تحرّم التحاكم إلى محاكم الغوص الجائرة، مؤكدًا وجوب الرجوع إلى الفقيه العادل.
- السيد هاشم البحراني، الذي اشتهر بصلابته في مواجهة الظلم ورفضه للخضوع للسلطة الجائرة.
ومن خلال هذه الممارسة الواقعية، يمكن القول إن فكرة ولاية الفقيه في البحرين لم تكن شعارًا نظريًا حديثًا، بل تجربة اجتماعية فعلية مارسها العلماء بوصفهم ضمير الأمة وممثليها الأخلاقيين.
🔹 خامسًا: الدلالات الفكرية والاجتماعية
- إعادة كتابة التاريخ البحراني ضرورة علمية، إذ ما زال كثير من فصوله مطموسًا أو مغيّبًا بفعل الإهمال أو التهميش المقصود.
- المدرسة البحرانية جمعت بين العلم والمقاومة، فكانت نموذجًا للفقيه المقاتل الذي يذود عن الدين والوطن في آنٍ واحد.
- المرجعية البحرانية كانت اجتماعية الطابع، تمارس مسؤولياتها في الإصلاح ومواجهة الظلم، لا تنغلق في دائرة الفتوى النظرية.
- العلاقة بين الفقيه والحاكم كانت علاقة توازن أخلاقي، حيث مثّل الفقيه الضمير الحي الذي يحدّ من استبداد السلطة.
- الهوية البحرانية بحاجة إلى استعادة رموزها الفكرية مثل الشيخ البلادي، لتستمد منها الثبات والمناعة الثقافية في مواجهة التحديات المعاصرة.
🔹 سادسًا: الخاتمة
ختامًا، فإن دراسة تجربة الشيخ ياسين البلادي ليست استذكارًا لشخصية تاريخية فحسب، بل هي إحياء لمرحلة فكرية تركت بصماتها العميقة في تشكيل الهوية البحرانية.
من هنا، تبرز الحاجة إلى:
- إعادة كتابة التاريخ البحراني بعيون بحرانية واعية بخصوصياتها الفكرية والاجتماعية.
- دراسة الشخصيات العلمية والسياسية بعمقٍ تحليلي يجمع بين الوثيقة التاريخية والرؤية الحضارية.
- استلهام التجارب الفقهية المقاومة لصياغة وعيٍ معاصرٍ يجمع بين الانفتاح والحفاظ على الجذور.
فالتاريخ ليس ذاكرةً جامدة، بل طاقة متجددة تستمد منها الأمة وعيها وهويتها.
وإنّ استحضار الشيخ ياسين البلادي وأمثاله هو استحضار لروح البحرين الأصيلة التي لا تموت، بل تتجدد في كل جيلٍ يعي مسؤولية العلم والجهاد والهوية.