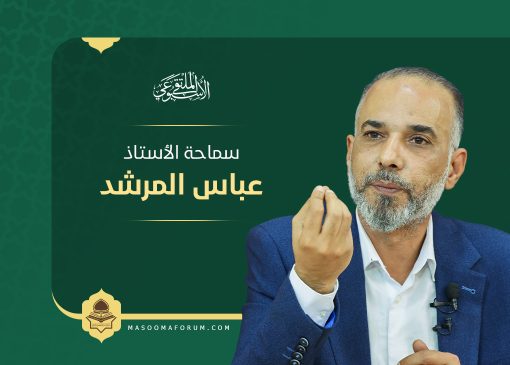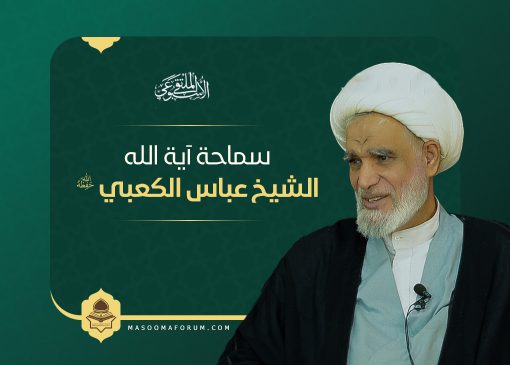اليوم الخامس – صفات أهل الفضائل
صفات أهل الفضائل
مع سماحة العلامة الشيخ حسين المعتوق.
التغطية المصورة:
التغطية الصوتية:
التغطية المكتوبة:
الموسم العاشورائي – محرم الحرام 1447 هجري
محاضرة اليوم الخامس تحت عنوان: صفات أهل الفضائل
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بحثنا اليوم بكلامٍ نوراني من إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: “شيعتنا العارفون بالله، العاملون بأمر الله، وأهل الفضائل”.
في هذه المحاضرة، سنتعمق في الشق الثالث من كلام الإمام في صفات المتقين وشيعة أمير المؤمنين، ألا وهو “أهل الفضائل“.
النقطة الأولى: ما معنى “أهل الفضائل”؟
“أهل الفضائل” أيها الأحبة، تعني أصحاب الصفات الروحية الصالحة. إنهم الذين نفوسهم طاهرة، ويسعون باستمرار لتطهير أنفسهم. هذا يُعدّ من الأمور الجوهرية التي لا بد لنا من السعي لها: اكتساب الفضائل والتخلص من الرذائل. لنرى ما نستفيده من النصوص الشريفة.
المستفاد من النصوص أن الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية:
أقسام الصفات الإيمانية
أولاً: الصفات الملازمة للإيمان: هذه الصفات يكشف وجودها عن وجود الإيمان، وانعدامها يكشف عن عدم الإيمان. أبرزها الصبر. يقول الحديث الشريف: “الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له”. من يفقد الصبر ليس مؤمناً بالمعنى الحقيقي، حتى لو كان مسلماً.
ثانياً: الصفات التي يتعارض عدمها مع الإيمان: هذه الصفات يجب ألا تكون موجودة في المؤمن، ووجودها يتعارض مع أصل الإيمان. مثالها الواضح هو العصبية. يقول الإمام الصادق (عليه السلام): “من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه”. العصبية هنا تشمل العصبية للذات (الإصرار على الخطأ)، العصبية للأفراد، للعرق، أو للجماعة. كل هذه الأنواع تخرج الإنسان من دائرة الإيمان الحقيقي.
ثالثا: الصفات التي تضعف الإيمان أو تسلبه: هذه الصفات إذا اشتدت، تسلب الإيمان، وفي درجاتها الأقل تضعفه. أبرز مثال هنا هو حب الدنيا. إذا بلغ حب الدنيا مرتبة معينة، فإنه يُفقد الإيمان، وفي مراتبه الأدنى، يضعفه.
رابعاً: الصفات التي يتحقق بها كمال الإيمان: هذه الصفات تُكمل إيمان المؤمن وترفعه. منها مداورة الناس (حسن التعامل) وكتمان السر. فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): “لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه فكتمان سره، وسنة من نبيه فمداورة الناس، وسنة من وليه فالصبر على البأساء والضراء”.
“النقطة الثانية: من أنا؟” وفلسفة بناء النفس
الآن، لنسأل أنفسنا: “من أنا؟” خلاصة شخصية الإنسان هي تاريخ أفعاله وانفعالاته التي شكلته. فلسفة التكليف أعمق من مجرد المصالح والمفاسد الظاهرية للأحكام الشرعية. هدفها الأسمى هو بناء النفس.
الدليل على ذلك واضح في القرآن الكريم: ”
﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ” (الشعراء: 88-89). وميزان النجاح الحقيقي هو تزكية النفس: ”
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾” (الأعلى: 14-15.
أي عمل نقوم به، إذا لم يؤدِ إلى طهارة النفس، فقيمته الحقيقية ضئيلة. السعي الحقيقي هو السعي لبناء النفس السليمة. لأنه لا شيء يُنجي يوم القيامة إلا القلب السليم.
مسؤوليتنا تجاه صفاتنا وأفعالنا
قد يقول قائل: الصفات النفسية كالحب والبغض والكبر ليست اختيارية مباشرة. نعم، هذا صحيح. لكن الإنسان مكلف بالتخلص من الأمراض النفسية (مثل الكبر والحقد) لأن أسبابها ومقدماتها اختيارية. المفاسد التي تنتهي إلى الاختيار تستوجب العقاب.
مواقف الإنسان مرتبطة بصفاته. لا يمكن أن يكون الفعل أفضل من الصفة. الحسن الفعلي يرجع إلى الحسن الفاعلي. لماذا؟ لأن كل أفعالنا هي في الأساس أفعال النفس. قيمتها ترجع إلى النفس، هل صدرت عن نفس صالحة أم نفس خبيثة؟
ولذا جاء في الحديث الشريف أن ضربة علي (عليه السلام) يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. هذا ممكن! لأن الفاعل، وهو أمير المؤمنين (عليه السلام)، صفاته النفسية لا تقاس بغيره في علاقته بالله وعشقه له. فقيمة أي فعل يصدر منه، سواء كان مشياً أو نظرة أو جلوساً، تعود إلى صفاته العالية.
لذا، ركعتان من إنسان صالح أفضل من ألف ركعة من شخص مليء بالصفات غير الصالحة. فصلاة الرياء لا قيمة لها مقارنة بصلاة من يعيش “كمال الانقطاع إليه تبارك وتعالى”. نحن لا يجب أن نركز فقط على شكل العمل، بل على الصفات الكامنة خلفه.
النقطة الثالثة: كيف نكتسب الصفات الحسنة؟
من أين تأتي الصفات؟ كيف تنشأ؟ العامل التراكمي (الكمي) وتكرار الأفعال يؤثران في تكوين الصفات. لكن العامل الكيفي أيضاً له دور كبير. انظروا إلى الحر بن يزيد الرياحي، الذي تحول في وقت قصير من قائد جيش الأعداء إلى ولي من أولياء الله بسبب رجوعه الكيفي إلى الحسين (عليه السلام). كذلك بعض شهداء كربلاء الذين بلغوا مراتب روحية عالية في سن مبكرة.
العامل التراكمي ليس شرطاً دائماً، لكن تكرار الفعل يؤثر. ومع ذلك، النداء القلبي والذكر الحقيقي هو الأهم، وليس مجرد تكرار الألفاظ. الذكر الحقيقي هو الذي يحجز صاحبه عن المعصية.
النقطة الرابعة: أهمية ذكر الله والارتباط به
يا أحبة، أول مسألة في بناء النفس هي الروح لله ومخاطبته. لا تكن رسمياً مع الله. خاطبه من القلب. “إلهي”، “ربي”، هو يعلم أنك تحبه، فقط أخبره بحبك له، أخبره بعلاقتك به. الله يحب أن يسمع منك.
آية الله المصباح (قدس سره) كان يوصي دائماً: “فليقطعوا أملهم عن غير الله، فليجعلوا الله يحل مشاكلهم، فلتكن قلوبهم متوجهة إلى الله عز وجل”. ذكر الله هو أفضل مطهر للقلب. لا شيء يتحقق بدون الارتباط بالله.
عش هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى. فهو أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين. الله يعطيك بكرمه، وكرمه لا تتصوره. تذكروا موسى (عليه السلام) الذي ذهب ليأتي أهله بقبس من النار، فرجع نبياً. “كل ما لا ترجون أرجى من كل ما ترجون”. يجب أن نذهب إلى الله بقلوب كبيرة، لا نحد عطاءه بمداركنا الضيقة.
النقطة الخامسة: متى نبدأ إصلاح أنفسنا؟
إصلاح النفس لا يرتبط بظرف خاص أو وقت معين. الحياة مبنية على الابتلاء، والابتلاء لن تتخلص منه. لكن الفرصة موجودة ما دمت حياً. عليك أن تبذل جهداً، ”
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾
العنكبوت: (69)
انظروا إلى أصحاب الحسين (عليه السلام)، بعضهم تعب على نفسه طويلاً، وبعضهم (مثل زهير والحر) نالوا تلك المراتب الروحية العالية في وقت قصير جداً، أو في ظرف شديد كأيام عاشوراء. هذا يؤكد أن الإرادة الصادقة والسعي الحثيث هما المفتاحان لبناء النفس وتزكية القلب.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته.